كتب الناقد الأردني زياد جيوسي
“منارة الموت” رواية من ضمن عدة روايات أصدرتها الكاتبة والروائية هناء عبيد من مغتربها في الولايات المتحدة. كنت قد قرأت لها قبل هذه روايتين جميلتين، غير أن هذه الرواية جذبتني بقوة من حيث الفكرة والسرد الروائي، على الرغم من جمال الفكرة في الروايات الأخرى. صدرت الرواية عن دار فضاءات للنشر والتوزيع في عمّان عام 2022، بغلاف جميل من تصميم الدار، يُصوّر شخصًا يجلس على الشاطئ يتأمل البحر والنوارس المحلقة، وكأنه يحاورها. أما الغلاف الخلفي فكان مقتطفًا من الرواية، وتقع الرواية في 234 صفحة من القطع المتوسط، وتبدأ بإهداء عاطفي جميل شمل الوالدين “رحمهما الله”، والأهل، والأصدقاء، و”آدم بطل الرواية، وكل صانع بسمة”. تتألف الرواية من عشرة فصول، وكل فصل منها ينقسم إلى عدة أجزاء معنونة بما يتناسب مع محتوى الفصل.
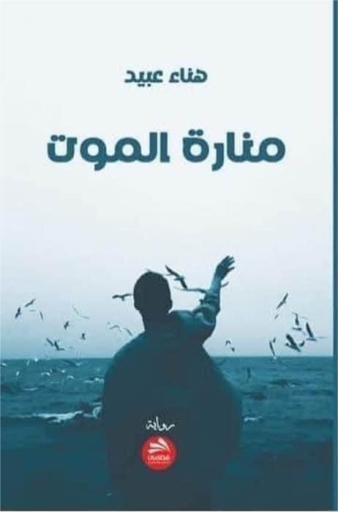
منذ الصفحات الأولى، يظهر بوضوح أن الرواية تدور حول سطوة رأس المال والمتنفذين، كما تتناول موضوعات مثل الفقر، والبؤس، والحب، والخيانة، والأمل، والتنمر. يتعرض “آدم”، الطفل الراوي، للتنمر من أطفال الحارة والمدرسة بسبب إعاقته الجسدية الناتجة عن تفاوت في طول قدميه، فيُلقب بـ”أبو رجل مسلوخة”، وهو لقب مستمد من حكاية تراثية تحمل الاسم ذاته. ولا يقتصر التنمر على الألفاظ، بل يمتد إلى الإيذاء الجسدي، ويتعدى ذلك ليطال والده، بائع الذرة على العربة، ووالدته التي تنشر الغسيل من الأسمال البالية. كل هذا يترك أثرًا نفسيًا عميقًا في آدم، فيقول:
“اليوم الذي سأنتقم فيه من كل من مرغ أنفي في الوحل، سيأتي، سيأتي حتمًا.”

ويتألم بشدة من خيانة حبيبته “هانا” التي تركته بعد دخولها الجامعة، بينما حرم هو منها بسبب الفقر، فيتساءل بحزن: “ماذا تعني لي الحياة دون هانا، صديقة طفولتي وحبيبة مراهقتي، ورفيقة عمري؟” ، عمل آدم بعد الثانوية في شركة “الأخوين كاربنتر” المتستّرة بالأعمال الخيرية. ولا أعلم إن كان من المصادفة أن هناك بالفعل شركة حقيقية تحمل الاسم ذاته تأسست في ريدنغ، بنسلفانيا عام 1889.
تتناول الرواية مشكلات اجتماعية عديدة، إلى جانب الفقر والتنمر، ومنها التفاوت الطبقي والتمييز العنصري والصراع المجتمعي. يظهر ذلك جليًا في شخصية “أبو نوى” الذي يحتقر الفقراء. فعندما تضع زوجته الطعام لآدم وأمه على طاولة المطبخ، يُصرّ هو على أن يجلسا على الأرض قائلاً: “الأرض موقع هؤلاء، لا يجب أن يتطاولوا على أسيادهم وإلا تمردوا.”
تكشف الرواية كذلك كيف أن الفقراء في مثل هذه المجتمعات “منذورون للموت”، وتتحدث عن مشاهد مهينة لتوزيع المساعدات التي ترميها شاحنات شركة “كاربنتر” من الأعلى، فيركض الناس إليها في مشهد يريق ماء الوجه، في حين تُمنح الحصص الكبرى للأقوياء، ويتصرف بها رئيس البلدية كيفما شاء لأغراض انتخابية، وما يتم توزيعه لا يتجاوز الخمس من المرسل بالشاحنات، والباقي من هذه الشاحنات ومن خلال السواقين والمشرفين تفرغ في مخازن التجار لبيعها للفقراء لصالح الشركة، فهم عبيد لدى “أصحاب الثروات الفاسدة”.
وتصف الكاتبة سوء البنية التحتية في المدرسة: جدران متهالكة، زجاج محطّم، اكتظاظ، ومدفأة صغيرة يحتكرها المدرس وحده، واصفة المدرسة بأنها “لا توحي بأنها دار علم”. كما أشارت إلى استغلال المشرفين في الفنادق لإكراميات العاملين.
تتطرق الرواية إلى الأعراف التي تمنع الفتيات من إكمال التعليم، كما في حال والدة آدم، فالتعليم بنظرهم “جرم في عرف العائلة التي ترى الزواج مآل الفتاة”، وإلى العنف الأسري، إذ يقول آدم عن والده:” مسكين، تربى في بيت لا يعرف من الرجولة سوى الخشونة في معاملة السيدات.”
ورغم أن البلدة توصف بالبائسة، إلا أن فيها قصورًا فارهة وفندقًا فخمًا، يسكنها أثرياء سلبوا أراضي الفقراء، ليحوّلوهم إلى عبيد يعملون لديهم، وقد أشار أبو الأحزان أن أراضيهم جرى الإستيلاء عليها من الإقطاع وطردوا منها، فأصبح يعمل عامل بناء، وأشارت أن “كل نزيه في هذه القرية سيعيش خاسرا مدى الحياة، فإما أن يرضخ للقوي، وإما أن تطرحه الكبرياء أرضا”.
وكذلك وصفت الفقر المدقع بحيث أن آدم وبسبب الفقر لم يدخل الجامعة رغم تفوقه الدراسي، فيقول: “فما ذنبي إن كنت أعيش في بلد لا توجد فيه عدالة، يتم تعليم من لهم سند وظهر وقوة ومال؟ ما ذنبي أني خلقت فقيرا”، إضافة وهو الملفت للنظر: لماذا ينحني الأب أمام صورة الرئيس في بيته، ومطلوب من آدم حين عمل في شركة “الأخوين كاربنتر” من خلال ندى، أن ينحني لصورة رئيس الشركة، وهذا يولد في داخل آدم الرفض لذلك ويطرح السؤال في البيت عن الرئيس: “من يكون هذا الرجل؟ أهو مبعوث الله من السماء أم مخلوق من معدن ذهب”. وتُطرح تساؤلات وجودية على لسان آدم، منها: ” لماذا ينحني أبي أمام صورة الرئيس؟”
تطرح الرواية كذلك نقدًا لاذعًا لمواقع التواصل التي يستعرض فيها الناس واقعًا زائفًا، فيقول آدم: “يبدو أننا جميعا نعشق الكذب، فنريد أن نظهر بشكل أجمل من حقيقتنا”، ولشركات الأدوية الفاسدة فهي: “لا تهمهمم أرواح الناس، يوزعون أدوية منتهية الصلاحية، فاسدة، إنهم فرع من فروع مافيا الأدوية”، ومافيات الإعلام، حيث تقول: “من يعارضهم يخفونه خلف الشمس.”
تُصوّر الرواية استغلال الشركات العملاقة، فتقول:”في الوطن المستبد عليك أن تكون وحشا بأنياب حادة، وإلا ستحل عليك ألف لعنة”، حين يُمنع زميل آدم “رمزي” من العلاج بعد إصابة عمل، فإصابات العمل غير مغطاة من الشركة، والإنسان لا قيمة له، وحين يفكر برفع قضية يصبح مهددا في حياته.
كما تسلط الضوء على الدعم الإنساني من قبل شخصية مثل “جورج”، الذي احتضن آدم وساعده على إكمال دراسته. فجورج، الذي فقد والدته بالأدوية الفاسدة، ثم انفصل عن خطيبته لأنها من يروج لهذه الأدوية، لكنه بقي مهتما بآدم فأسكنه عنده وشغله بحديقته وبيته، ودعمه ليحصل من خلال دعم صديقه على منحة لدراسة الطب، في أفضل جامعة في الوطن.
ورغم رقي هذه الجامعة فقد كان الطلاب من أبناء الأثرياء يقاطعونه ويسخرون منه لإعاقته وفقره، فيقول آدم: “نظرات الطلاب تزدريني أينما كنت، ما أبشع أن تتواجد في عالم لا تنتمي إليه”، كما أشارت الكاتبة للتمييز ضد أصحاب الإحتياجات الخاصة، فآدم تم رفض تعيينه بوظيفة في أي عمل تقدم له رغم تفوقه.
الرواية تكشف عن تجارة أعضاء وأدوية فاسدة تُوزع على الفقراء، وعن شاحنة سرية تنقل تلك المواد في الليل، وقتلت ريان الذي حاول كشف الحقيقة، وهذا ما جعل آدم يستقيل من الشركة بعد هذه الأحداث خوفا على نفسه، ليعود للعمل في المقهى.
المسرح المكاني والزماني: رغم أن الرواية لا تصرّح بالمكان، إلا أن المؤشرات (الدولار، اسم الشركة، وسائل المعيشة) توحي بأن الأحداث تدور في أمريكا، ولكن الإسقاطات التي تمارسها الكاتبة تجعل من الممكن قراءة الرواية كمرآة لوضع عربي يعاني التهميش والقهر. وتتجلى رمزية الزمان في وجود “إنترنت” وقطار وسوق حديثة، في مقابل البؤس الذي يحيط بكل شيء، فالزمان حديث العهد نسبيا فهناك مقهى بالقرية فيه “انترنت”، وكذلك في مدينة الأنوار على بعد ساعتين من القرية بالقطار وهي بائسة أيضا، حيث يقول آدم: “المدينة لا تختلف كثيرا عن القرية، كدت أسقط في عدة حفر، لا يوجد ممر مشاة، الشوارع غير مرصوفة، تغطي القمامة معظم المساحات المقابلة للمحلات التجارية”.
وحين عمل آدم في مقهى وردت عبارة: “تصطف في المطبخ زجاجات النرجيلة” وهذا الوصف ينطبق على مقاهي البلدات العربية، ولا أعلم إن كانت يوجد في مقاهي بهذه الصفة في البلدات الإمريكية، وكذلك الأسماء التي وردت عربية مثل ندى دليل المجموعة السياحية، وزملاء آدم في العمل، وأبو الأحزان والد الطفل سام المصاب بمرض، والغريب أنه لم يرسله للمدرسة حتى لا يتم التنمر عليه، فهل القوانين في أمريكا تسمح بذلك.
ويلاحظ قول آدم لنفسه: “لماذا لا يعاقب الله من يسرقون قوتنا، ويقتلون الإنسانية، ويدمرون الأوطان”، فهل أمريكا هي الوطن؟ أم يقصد مكان آخر يعيش فيه، فنجد في ص 65 وردت فقرة على لسان آدم تقول: “إنها المؤامرة التي تقصد الفقراء، مرض وفقر وموت، وأرض تقسو على ساكنيها، أنظمة تمتص حليب أطفالها”، ولكن ما لفت نظري قوله بعدها: “ماذا لو تفوهت بكلمة ضد الأنظمة؟ حتما سأجدني أسير قضبان تركلني فيها أقدام”، وفي ص 69 قال والد آدم عبارة ربما قرأها في جريدة: “هذا حال البلاد التي لا تحكمها القوانين الصارمة، كل يريد أن يتخطى القانون، فهو يعلم أنه لن يأخذ حقه إلا بالصراع”.
فهل آدم والقرية تحت حكم نظام من أنظمة العالم الثالث؟ وهل هذه الظروف البائسة موجودة فعليا في أمريكا، أم هي عملية اسقاط قامت بها الراوية على دول عربية؟
شخصيات الرواية: آدم وهو الراوي الرئيس للرواية، الفقير المعاق، يمثل صوت المهمشين. جورج: صحفي سابق، دعم آدم وسعى لفضح الشركة، وهو الشخصية الثانية، ويروي على لسانه اربعة أجزاء من فصول الرواية، ويسعى للعمل فيها لكي يحصل على ما يكفي من معلومات لفضح الشركة، وفيها يشير لطرده من عمله بالصحافة لانتقاده النظام، ويتمكن من إعلان إضراب بالشركة لمقاومة الظلم الواقع على العمال، لكن الإضراب يفشل بعد شهر بسبب الفقر وعدم استلام مستحقات مالية من الشركة، وحسب ما ورد في ص 205 أن “إختفاء الرغيف يصنع ذلا يعمي الأبصار”، فيطرد جورج من العمل ولكنه يبدأ بنشر مقالات تفضح الشركة على وسائل التواصل الإجتماعي، فالصحف مسيطر عليها وترفض أن تنشر له، ويبقى على تواصل مع بعض العمال “هؤلاء الذين آثروا كرامتهم على رغيف الخبز”. ولكنه قُتل لاحقًا.
هانا جارة آدم وصديقة طفولته والفتاة التي أحبها ولكنها ابتعدت عنه لظروفه المالية، وحين حاولت العودة رفضها آدم حفظا لكرامته، وهمس في داخله: “أنتِ تريدين ورداً مقلم الأغصان”، وعلى لسانها وردت بعض من أجزاء الرواية بمساحة محدودة، وتعدد الأصوات في الرواية أعطى المساحة للشخصيات المهمة، وأعطى للرواية بؤر سردية متعددة، ويليها شمس التي أحبها آدم بصمت، شمس التي تمثل أنها بكماء لتحصل على العمل وتكشف لجورج وآدم سر اختفاء ريان، فقتلت لاحقا بعد كشفها للفساد.
وباقي الشخصيات الثانوية مع اختلاف أدوارها ،كانت والد آدم بائع الذرة والضعيف أمام التنمر، والدة آدم “جودي ذات الاثني عشر ربيعا، إختارها والدها الكسول المشبع بالنذالة، لتتحمل المسؤولية قبل أوان اشتداد عودها”، وأخته سيلينا والطفل نوى، وأم نُوى ثرية تستخدم والدة آدم لتنظيف بيتها الفخم، لكن زوجها يتعامل مع الفقراء باحتقار، صاحب المقهى، زملاء العمل جورج وريان ورمزي، جورج ظروفه جيدة ومع ذلك يعمل في الشركة بأجر زهيد لهدف يسعى اليه ولا يكشف لآدم سر ذلك إلا متأخرا، أبو الأحزان أيضا ولفت نظري علاقة الصداقة التي نشأت بين أبو الأحزان الكبير بالعمر، وآدم الذي ما زال طالبا بالمدرسة، ففارق العمر كبير، وبالتأكيد ان آدم ليس في عمر يسمح بهذه الصداقة وأن يبوح أبو الأحزان له بظروفه الصعبة.
وقد استطاعت الكاتبة أن توظف شخصيات الرواية لخدمة الرواية، سواء الشخصيات الرئيسة أو الثانوية، وكان لكل شخصية دورها وتأثيرها في الفكرة التي قامت عليها الرواية وفي السرد الروائي، فكان آدم رمزا للفرد المهمش والفقير والمعرض للتنمر بسبب إعاقته، ولكنه في نفس الوقت كان رمزا على الإصرار والمقاومة، وكذلك سلطت الضوء على مجموعة من الشخصيات الثانوية من المهمشين، والتي تعاني إعاقات مختلفة مثل متلازمة داون والتلعثم والصمم والعمى وغيرها من اعاقات، فعرت الكاتبة سلوك المجتمعات تجاه المهمشين بسبب الاعاقات، بجرأة وقوة وبروح انسانية متضامنة معهم، فهم بشر ولديهم قدرات مختلفة، وكلهم ساهموا في بناء العالم الروائي، مما منح الشخصيات فسحة للتعبير عن ذواتها ووفر تنوعا سرديا.
وكذلك توظيف عنوان الرواية حيث وظفت الكاتبة التناقض بين “المنارة” و”الموت” في العنوان توظيفًا رمزيًا دقيقًا فكان هذا التباين والتناقض هو أساس البناء السردي للرواية، وظهر هذا بوضوح في حوار الذات لدى آدم، والحوار الخارجي حيث جمعة اللغة بين البساطة والعمق.
وفي النهاية نجد أنفسنا أمام رواية اجتماعية وسياسية بإمتياز، وتجربة ثرية فكريا واجتماعيا وإنسانيا، تنطلق من مأساة فرد لتصف واقعًا جمعيًّا مظلمًا. رواية ثرية بالفكر، تفيض بالوجع، لكنها تزرع الأمل عبر شخصيات مقاومة تؤمن بأن البسمة والمساعدة والتعليم، هي أدوات الخلاص، تغوص في رحلة لشخوص الرواية بين الحب والقسوة، الحياة والموت، المقاومة والإستسلام، العتمة والنور، تنوعت اللغة بين البساطة والعمق، وتراوحت بين السرد الخارجي والحوار الداخلي، ما أضفى على الرواية عمقًا نفسيًا وإنسانيًا. كتبت رغم تشاؤمها بلغة سلسة وقوية وسرد داخلي قوي، والدخول للعمق النفسي لشخوص الرواية، تسلسل روائي وسرد ممتع بدون ملل، شخصت الواقع الذي تتحدث عنه بقوة، حيث الظلم والتطاول على القانون، وحيث الحيتان من الأغنياء تعيش وتلتهم الأسماك الصغيرة من الفقراء، حيتان تمتلك القوة والسطوة، تقتل كل من يعارضها أو يسعى لكشف المستور عنها، فيتعرض آدم للضرب بهرواة ثقيلة تكاد تقتله، ظنا أنه جورج أو رسالة لجورج، وتقتل شمس في قبو بيت جورج بعد تقييدها وربما لأنها تعمل مع جورج، وافتراضيا لأنها كشفت له ما رأته في عملها، فيتولد الرفض ويتجذر في روح آدم فيقول: “أن نقول نعم دوما يعني أن هناك أصفادا تخنقنا، تجعلنا نسير خلف ما لا ترغب به أرواحنا، وما أن ننعتق من القيد حتى تصبح (لا) كلمة روتينية لا نستصعب قولها”، ويترجم ذلك بإكمال دراسته العليا بعد رفضه بالوظائف، ويصبح مدرسا في كلية الطب، ويساعد أخته لتكمل دراستها وتتخرج من كلية التربية، وتفتح محل للورود في القرية وتزرع البسمات على وجوه الأحبة والأطفال وهدفها أن تكون من صناع البسمة، حتى يفتتح آدم عيادته، ويعالج المحتاجين والمعدمين مجانا، فكانت رواية عبرت عن صوت المهمشين في الأرض، بلغة تحمل تداخلا بين الفلسفة والرمزية والمجاز.
وختاما أعود للسؤال الذي وضعته عنوانا: مع رواية منارة الموت.. من سينتصر؟ الحب أم الرصاصة، فجورج يؤمن أيضا أن “العنف يقاوم بالعنف، والحق يؤخذ بالقوة”، ويقول: “أريد عدالة ونهاية للظلم، قلمي هو سلاحي الوحيد الذي أحارب من خلاله”، بقي يحارب بقلمه حتى قتلته الرصاصة، وآدم كان يحارب بمساعدة الآخرين وزرع البسمة على وجوههم، فهو يرى أن “البسمة سلاح البؤساء”، وكانت قناعته من خلال عبارة قالها له جورج يوما: “أن تقاتل الجهل معناه أن تنشر الشمس والضياء”، فكانت نهاية الرواية ترك الخيار للمهمشين بالمقاومة الفعلية سواء بالقلم وغيره من وسائل المقاومة كما فعل جورج، أو من خلال تضامن المهمشين انسانيا كما فعل آدم… ولعل الإجابة على سؤالي في العبارات الأخيرة من الرواية: “ستخترق السماء أغنية تصدح عاليا، ستنتصر البسمة أيها الطغاة”.
“عمَّان 20/6/2025”